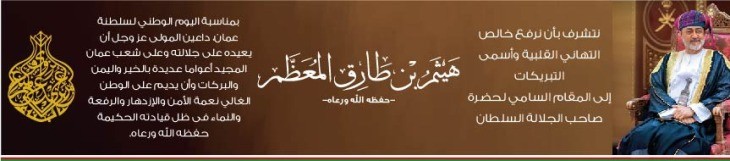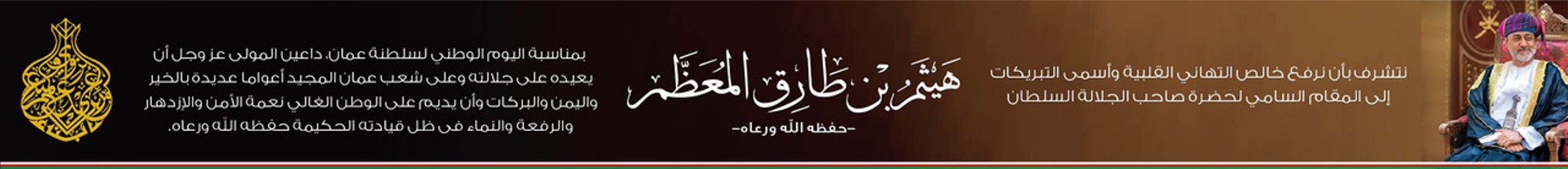الطليعة الشحرية
يقولون إنَّ الإقطاع انتهى، وإننا اليوم في عصر الحُرية، الديمقراطية، وحقوق الإنسان. الحقيقة؟ لم ينتهِ شيء… فقط باع الفلاح حصانه واشتروا له هاتفًا ذكيًا، في الماضي كان الفلاح يحرث أرض الإقطاعي ويُعطيه العُشر، أما اليوم فهو يفتح "الفيسبوك" ليزرع منشورًا، فيحصد الإقطاعي كل بياناته، وصار العُشر 100% من وعيه.
القلعة القديمة كانت تُبنى من الحجارة، أما اليوم فهي سحابة "Cloud" محاطة بجدران الشروط والأحكام "Terms & Conditions" أطول من سور الصين العظيم، ونحن نضغط على زر "موافق" مثل قطيع مُطيع لا يقرأ شيئًا. في القرون الوسطى، كانوا يجلدونك إذا خرجت عن طاعة السيد، أما في عصر الخوارزميات، يكفي أن تكتب تغريدة ساخرة حتى تُنفى إلى منفى رقمي، حسابك محجوب، صوتك مبحوح، وأنت خارج الحظيرة. والأجمل؟ أنَّ العبيد الجدد يصفقون لجلاديهم ويهتفون؛ "شكرًا زوكربيرغ أعطيتنا زر لايك"، "تحيا جوجل! من دونك لا نعرف حتى كيف نذهب إلى أقرب استراحة!"
نحن لا نعيش نهاية الإقطاع؛ بل نعيش نسخته المُحدثة 2.0، حيث يرتدي السادة تيشيرتات قطنية ويجلسون على مقاعد الاسترخاء (beanbag) في وادي السيليكون، بينما الفلاحون يتطوعون بإطعام أسيادهم بالصور والرسائل والمحادثات الحميمة مجانًا.
لم يعد الإقطاعي الحديث بحاجة إلى سيف أو درع، فالرأسمالي تكفّل بمنحه أسلحة أكثر فتكًا، رأس المال الجشع، والاستثمارات العمياء، ومصارف تتفنن في إعادة تدوير الأرباح. هكذا وُلد تحالف جديد؛ الإقطاعي الرقمي الذي يملك القلاع (الخوارزميات والمنصات) مع الرأسمالي الذي يضخ الأموال مقابل السيطرة على الأسواق. الأول يحصد البيانات، والثاني يحوّلها إلى أرباح وأسواق احتكار، وفي المنتصف يبقى المستخدم/المواطن مجرد فلاح رقمي يزرع يومه في حقول التطبيقات، ويحصد الآخرون ثماره. إنّه زواج مصلحة بين القلعة القديمة والبورصة الحديثة، اتحاد لا يُفرّق بين السوط والربح، لأنَّ الاثنين يؤديان إلى النتيجة نفسها؛ العبودية المُقنّعة بثوب من حرية رقمية زائفة.
يقوم الإقطاع الرقمي على 5 ركائز مترابطة تشكّل بنيانه الصلب، أولها رأسمالية المنصة؛ حيث تتحول الشركات الكبرى إلى وسطاء أو حراس بوابات يربطون المشترين بالبائعين والمعلنين بالمستهلكين، لكن مقابل "ضريبة مرور" لا تنقطع.
وثانيها اقتصاد الانتباه؛ إذ تُعيد الخوارزميات توزيع وقتنا ووعينا بطريقة تضمن أكبر عائد إعلاني، فتتحول الدقائق والثواني إلى عملة نادرة في يد الشركات. أما الركيزة الثالثة؛ فهي السحابة والبنية التحتية؛ فالقوة الحقيقية صارت فيمن يمتلك مراكز البيانات العملاقة، والرقاقات الدقيقة، وشبكات الاتصال التي تُشكّل أساس أي اقتصاد رقمي. وتأتي بعدها الركيزة الرابعة: النماذج الضخمة والملكية الفكرية؛ حيث أصبحت أنظمة الذكاء الاصطناعي باهظة الكلفة وأسرارها البرمجية محمية بقوانين تجعل دخول المنافسين الجدد إلى الساحة أمرًا شبه مستحيل.
وأخيرًا، هناك السياسة العامة التي تتأثر بجماعات الضغط المتنوعة- من التكنولوجيا والمال إلى الدواء والطاقة، مرورًا بجماعات مؤيدة لإسرائيل وغيرها- ما يجعل القوانين والضرائب وسياسات المنافسة والخصوصية تُصاغ بما يخدم مصالح هذه القوى، في نظام عالمي متعدد الأذرع، لا تحكمه هوية دينية أو عرقية واحدة بل شبكة مصالح مُعقدة.
تقوم هيمنة المنصات الرقمية على مجموعة من الآليات التي تُحكم قبضتها على السوق وتُصعّب على المنافسين الدخول أو الصمود. تبدأ بالتأثير الشبكي، فكلما ازداد عدد المستخدمين ارتفعت قيمة المنصة، مما يجعل الانتقال إلى بديل شبه مستحيل.
ثم تأتي سياسة إغلاق الواجهات التي تقلّص التشغيل البيني وتجعل الخروج من النظام مكلفًا ومعقدًا، وإلى جانب ذلك تعتمد الشركات على عمليات الاستحواذ بشراء المنافسين الصغار قبل أن يكبروا ويشكّلوا تهديدًا. كما تُستخدم استراتيجيات التسعير المفترس والربط عبر دمج عدة خدمات في باقة واحدة لخنق أي بديل مستقل. وعلى مستوى العمل، تتجلى السيطرة في الإدارة الخوارزمية للعمل، حيث يتم توجيه السائقين أو مقدمي الخدمات بنماذج تقييم وتخصيص غير مرئية ولا تخضع للمراجعة.
وأخيرًا، هناك التجميع الرأسي الذي يدمج كل السلسلة الرقمية تحت سقف واحد، من تصميم الرقاقة إلى تشغيل السحابة وصولًا إلى التطبيق الذي يستخدمه الفرد، ما يجعل المنصة قادرة على التحكم الكامل في كل حلقة من حلقات الإنتاج والاستهلاك.
الإقطاع الرقمي يشبه الإقطاع القديم، لكن بنكهة "هاي تيك"، الفلاح سابقًا كان يزرع في أرض ليست له، واليوم يزرع منشوراته في "فيسبوك" أو "تيك توك"؛ أرض رقمية لا يملك منها حتى البذور. الريع القديم كان عُشر المحصول، أما الريع الحديث فهو اشتراكات شهرية، وعمولات سوق، واقتطاع من أرباحك حتى لو بعت جوربين أونلاين.
القانون؟ لم يعد "قانون الغابة"؛ بل "شروط الخدمة"؛ وثيقة مكتوبة بلغة فضائية، نضغط على "موافق" كأننا نبيع روحنا دون أن نفهم سطرًا واحدًا منها، وفي الماضي كان الفلاح إذا حاول الهرب يطارده حراس القلعة، أما اليوم فإذا حاولت مغادرة المنصة تكتشف أنك فقدت جمهورك، تقييماتك، وحتى ذاكرتك الرقمية، فتعود صاغرًا إلى حضن السيد الرقمي، شاكرًا له لأنه سمح لك بالبقاء "عبدًا مميزًا" مع شارة زرقاء بجانب اسمك.
القواعد في عصر الإقطاع الرقمي لا تُكتب في البرلمان ولا في الدستور، بل تُطبخ في مطابخ نفوذ خفية، البداية مع تمويل الحملات؛ حقائب من التبرعات الانتخابية تُمرَّر بسلاسة، والمسؤول الذي كان "يمثل الشعب" بالأمس يصبح "مستشارًا استراتيجيًا" للشركة اليوم باب دوّار يفتح على خزائن من ذهب.
ثم يأتي دور الإعلام، وهو أشبه بمُهرّج البلاط؛ يضخّم ما يريد السيد أن يراه الشعب، ويخفي ما قد يزعج العروش الرقمية، حتى تختفي الحقائق أسرع من منشور مخالف على فيسبوك، وأما اللوبيات فهي السيرك الكبير: تكنولوجية، مالية، طاقة، دوائية، زراعية، وحتى دينية أو قومية كلّها تصرخ في أذن المشرّع: "اكتب القانون على مقاسنا!".
بعضهم مؤيد لإسرائيل، آخرون يدافعون عن النفط أو الدواء أو حتى الخيار البلدي، لكن النتيجة واحدة قوانين تُخاط حسب مقاسات الجيوب، لا مقاسات العدالة. وبالطبع، نحن الجمهور نضحك ونصفق، ظانّين أننا في "ديمقراطية"، بينما نحن مجرد كومبارس في مسرحية عنوانها" السياسة تصنعها الجيوب، لا الشعوب".
الجغرافيا السياسية للإقطاع الرقمي تبدو كأنها مسرحية عالمية سيئة الإخراج؛ في الزاوية الأولى يجلس وادي السيليكون، يوزع نماذج الذكاء الاصطناعي مثل بطاقات بوكر، ويستثمر رأس المال المغامر وكأنه يلعب بلايستيشن. في الجهة المقابلة تقف الصين، تسيطر على سلاسل الإمداد وتصنع الرقاقات كأنها حبات أرز، وتُشغّل منصات محلية عملاقة تحت شعار "السيادة الرقمية ذات الخصائص الصينية".
أما الاتحاد الأوروبي فهو أشبه بمدرس صارم يحمل دفتر قوانين الخصوصية والمنافسة، لكن مشكلته أنه لا يملك تلاميذ عمالقة ليعاقبهم سوى بالغرامات البيروقراطية، وبينهما يقف الخليج وآسيا بدور المستثمر الهادئ، يصب أمواله في مراكز بيانات وطاقة ويعقد شراكات ذكاء اصطناعي كما لو كان يشتري ناطحات سحاب جديدة.
خلال العقد القادم قد يعيش البشر واحدًا في أشد سيناريو هات شؤما هو أن يتحول الإنسان إلى رقم في نظام "ائتمانات سلوكية"؛ وظيفة، قرض، وحتى دخول مستشفى مشروط بدرجة خوارزمية، كأن حياتك بطاقة نقاط سوبرماركت، وستبقى قبضات المنصات مشدودة لكن مع بعض الرتوش التجميلية: غرامات شكلية، تشغيل بيني محدود، وتدقيق خوارزمي جزئي يقال إنه لحمايتك بينما هو مجرد ديكور. ومن باب التفاؤل، فهو حلم أشبه باليوتوبيا: بياناتك تنتقل معك كما تنتقل حقيبة يدك، هوية رقمية عامة تدار تعاونيًا، وبريد مفتوح المصدر بدل أن يبقى مرهونًا بالعمالقة. وهنا السؤال الجاد (والساخر في الوقت نفسه): كيف نحمي أنفسنا كأفراد؟ بين مكافحة الاحتكار، وحق ملكية بياناتك كما لو كانت عقارك، وشفافية الإعلانات حتى تعرف أي خوارزمية اشترت دماغك اليوم يبدو أن المستقبل ليس صراع دول فقط، بل معركة كل واحد منَّا ضد أن يتحول إلى فلاح رقمي منزوع السيادة على وعيه.
الإقطاع الرقمي ليس قدرًا مكتوبًا على لوح سماوي، بل نتيجة خيارات سياسية واقتصادية قابلة للتغيير؛ لكن بدل أن نواجهه بجدية، نقضي وقتنا في مطاردة أوهام الهوية العرقية والدينية بينما المشكلة الحقيقية هي أن القوة والريع والقرارات الخوارزمية صارت خارج أي مساءلة.
وهكذا نجد الدول مهدَّدة في سيادتها من أربع جبهات: أولًا التحكم بالبيانات، حيث الموارد الاستراتيجية لم تعد نفطًا ولا ذهبًا، بل خوادم في كاليفورنيا تُخزَّن فيها بياناتنا وكأنها وديعة بنكية برسم المصادرة عند أول خلاف سياسي، ثانيًا البنية التحتية الرقمية، إذ تكتشف كثير من الحكومات أنها تبني اقتصادها فوق سحابة أجنبية قد تمطر عليها "حظرًا تقنيًا" في أي لحظة. ثالثًا التأثير الإعلامي، فالسرديات الوطنية لم تعد تُصاغ في وزارات وهيئات الإعلام؛ بل في مكاتب وادي السيليكون أو شِنزن؛ حيث زر "الترند" أقوى من أي وزارة خارجية. رابعًا القرارات المؤتمتة؛ إذ يمكن أن تجد دولة بكاملها تتحول إلى "زبون ممتاز" لخوارزمية توظيف أو نظام مالي أجنبي، وكأنها تشترك في خدمة "نتفليكس سيادي".
في ظل هذا الوضع، لا غرابة أن نشهد سباق تسلح بالذكاء الاصطناعي أشبه بنووي القرن العشرين، وحروبًا سيبرانية قادرة على إطفاء أنوار مدينة كاملة بنقرة كود، واقتصادًا رقميًا مقسومًا إلى "جزر سيادية" كل منها يحرسه جدار ناري، مع دبلوماسية بيانات تحوّل اتفاقيات التخزين والتبادل إلى نفط وغاز القرن الحادي والعشرين، فما الخيارات أمام الدول؟
بعضهم يرفع شعار السيادة التقنية ببناء مراكز بيانات محلية وصناعة رقاقات، وكأنها عودة إلى الزراعة لكن بلغة السيليكون. وآخرون يلجأون إلى قوانين سيادة البيانات، يفرضون تخزينًا محليًا وشفافية شكلية في الخوارزميات، حتى لا يقول المواطن إن دولته عاجزة. وهناك من يجرّب التحالفات الرقمية؛ دول متوسطة وصغيرة تحاول تكوين بدائل جماعية لهيمنة واشنطن وبكين، تمامًا كفلاحين يتفقون على زراعة جماعية بعيدًا عن الإقطاعي.
أما الحل الأكثر طرافة فهو التربية والوعي؛ تعليم "المواطنة الرقمية" في المدارس حتى يحفظ الأطفال مبكرًا أن الضغط على "أوافق" ليس عملًا بريئًا؛ بل عقد عبودية إلكتروني. باختصار، الدول أمام خيارين أن تصير فلاحًا رقميًا في مزرعة الآخرين، أو أن تجرّب بناء مزرعتها الخاصة وإن كان السماد هذه المرة اسمه الذكاء الاصطناعي.
مستقبل سيادة الدول يبدو وكأنه عرض مسرحي عبثي من 3 فصول؛ في الفصل الأول، سيناريو فقدان السيادة دول كاملة تتحول إلى "مستعمرات رقمية"، تستهلك سحابات وخوارزميات أجنبية، وتنتظر قرارًا من وادي السيليكون أو بكين لتعرف إن كان مسموحًا لها أن تُشغّل تطبيقات مواطنيها. الفصل الثاني، سيناريو التعددية الرقمية: العالم ينقسم إلى أحياء رقمية مسوّرة؛ حي أمريكي بواجهات لامعة، حي صيني بنظام سيادة محكم، حي أوروبي مشغول بتوزيع غرامات بدل بناء منصات، وربما حي عربي/إفريقي يحاول اللحاق بالركب عبر صناديق سيادية، كأنه "مركز تجاري" ملحق بالمدينة الكبرى. أما الفصل الثالث فهو الأكثر تفاؤلًا هو سيناريو الحوكمة المشتركة، حيث تجتمع الدول في مؤسسة دولية جديدة، نسخة مطوّرة من الأمم المتحدة، لكن اسمها الحقيقي سيكون؛ مجلس الإقطاعيين الرقمي. وهناك، يجلس أصحاب المنصات الكبرى على الطاولات المستديرة يوزعون الخوارزميات كما تُوزَّع الحقائب الوزارية، ويتجادلون بخطب رنانة عن العدالة والشفافية، بينما يوقّع البقية على القرارات مثل شاهٍ مُطيعة.
مشهد أشبه بذئاب ترتدي بدلات رسمية وتكتب دستورًا لحماية الغنم مع تصفيق حار من الإعلام الذي يعلن للعالم "لقد انتصرت الديمقراطية الرقمية!".
والخلاصة.. حرب الخوارزميات اليوم تُهدد سيادة الدول كما هدد السلاح النووي التوازن الدولي في القرن الماضي، لكن الفارق أن القنبلة الذرية كانت مرئية، بينما القنبلة الخوارزمية تتسلل إلى جيوبنا ووعينا بلا ضوضاء، ومن لا يملك استراتيجية وطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي فلن يكون أكثر من تابع رقمي في نظام عالمي جديد يرفع علمه لكن قراره محفوظ في "سيرفر" على بُعد قارة.